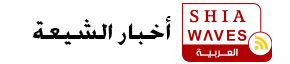في الأول من أيار من كل عام، يتوقف العالم عند محطة فارقة في مسيرة العدالة الاجتماعية، إنها مناسبة “يوم العمال العالمي”، التي تحتفي بملايين الأيدي العاملة التي تشكل العمود الفقري للمجتمعات والاقتصادات حول العالم، وتُسلط الضوء على قضاياهم المتجددة وسط تحولات متسارعة تشهدها بيئة العمل.
تعود جذور هذا اليوم إلى مدينة شيكاغو الأميركية عام 1886، حين خرج العمال في احتجاجات واسعة للمطالبة بتحديد يوم العمل بثماني ساعات، في وجه ظروف قاسية كانت تخلو من أي ضمانات صحية أو قانونية. وقد واجهت الحركة العمالية آنذاك قمعًا دمويًا، لكن تضحياتها أرست دعائم واحدة من أوسع الحركات المطالِبة بالحقوق في التاريخ الحديث.
ويحيي العالم هذا اليوم من خلال فعاليات ومسيرات وندوات تنظمها النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية، لتجديد المطالب بالعدالة الاجتماعية، والرواتب المنصفة، وظروف العمل الآمنة، والحماية من التسريح التعسفي. وتختلف القضايا باختلاف السياقات، ففي الدول المتقدمة تتركز المطالب حول تحسين شروط العمل، فيما تتخذ في الدول النامية طابعًا أكثر حدة بفعل ارتفاع نسب البطالة وضعف الضمانات القانونية.
وقد فرضت التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية تحديات جديدة على واقع العمالة، أبرزها أتمتة الوظائف، والعمل عن بُعد، واتساع ما يُعرف بالاقتصاد غير الرسمي، حيث يُحرم الملايين من الحقوق الأساسية كالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، إلى جانب استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وفي العالم العربي، لا تزال شرائح واسعة من الطبقة العاملة تواجه تحديات متجذرة، من أبرزها تدني الحد الأدنى للأجور، وغياب التمثيل النقابي الفاعل، في مقابل بوادر إصلاح تشهدها بعض الدول لتعديل قوانين العمل وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما بعد دروس جائحة كورونا التي كشفت هشاشة الوضع العمالي في العديد من القطاعات.
ويمثّل عيد العمال تذكيرًا بأن العمل ليس مجرد أداة للكسب، بل هو حق أصيل وركيزة للكرامة الإنسانية، تتقاسم مسؤولياته الدولة وأرباب العمل والمجتمع على حد سواء. ففي عالم يتغير بوتيرة متسارعة، يظل الأول من أيار وقفة سنوية تؤكد أن صون حقوق العمال لا يتحقق إلا عبر النضال والتشريعات العادلة والتضامن الإنساني.
ويظل تكريم العامل الحقيقي مرهونًا ببناء بيئة عمل تحترم إنسانيته، وتكفل حقوقه، وتُعزز دوره في صناعة مستقبل أكثر عدلًا وشراكة.