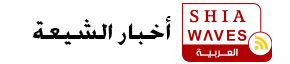التعليم يتحول إلى أداة تمييز ديني.. إقصاء فتاة مسلمة من مدرسة هندية يثير غضباً واسعاً

في حادثة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، تفجّرت في مدينة ناجبور الهندية فضيحة تمييز ديني بعد الكشف عن رفض مدرسة قبول فتاة مسلمة فقط بسبب ديانتها، في ما وصفه ناشطون بـ”جريمة تعليمية مكتملة الأركان”.
القضية بدأت حين تقدّم والدا الطفلة بشكوى رسمية إلى لجنة الأقليات في ولاية ماهاراشترا، أكدوا فيها أن ابنتهما حُرمت من حقها في التعليم للعام الدراسي 2025-2026 على خلفية انتمائها الديني، رغم استيفائها لجميع شروط القبول. وأشار الوالدان إلى أن المدرسة المعنية، “داياناند أريا كانيا فيديالايا”، رفضت تسليم استمارة التسجيل للطفلة، في إجراء بدا ممنهجًا ضد الطالبات المسلمات.
وبناءً على الشكوى، أمر رئيس لجنة الأقليات، بياري خان، بفتح تحقيق رسمي تشارك فيه وزارتا التعليم وتنمية المرأة والطفل، لتتضح لاحقًا معالم فضيحة أثارت صدمة واسعة: فقد تبيّن أن السكرتير الإداري للمدرسة، راجيش لالواني، أصدر تعليمات صريحة إلى المعلمين بعدم قبول أي طالبة مسلمة. كما جرى التلاعب باستمارات التسجيل، واختُلقت ذرائع زائفة مثل “عدم وجود مقاعد شاغرة”، في محاولة لإخفاء التمييز الديني.
المفاجأة الأكبر جاءت من داخل المدرسة نفسها، حين تقدّمت المديرة، جيتا هارواني، بشكوى ضد السكرتير، كشفت فيها عن ضغوط متكررة تُمارس على الطاقم التعليمي لمنع التحاق المسلمين بالمؤسسة، ونددت بما وصفته بـ”مناخ تمييزي خطير يقوّض رسالة التعليم”.
وفي تطور لاحق، فتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا ضد لالواني والمعلمة سيمران جيانشانداني، ووجّهت إليهما تهمًا بموجب المادة 299 من قانون “بهاراتيا نيايا سانهيتا” لعام 2023، والتي تُجرّم الأفعال المتعمدة التي تُسيء للمعتقدات الدينية وتؤدي إلى التفرقة المجتمعية.
من جانبه، شدّد رئيس لجنة الأقليات على أن التعليم حق دستوري لا يمكن ربطه بالدين أو الطائفة، مؤكداً أن من “يجرؤ على انتهاك هذا الحق المقدس سيواجه أشد العقوبات”.
وأثارت الحادثة تساؤلات عميقة حول حيادية النظام التعليمي في بعض مناطق الهند، مع تزايد مؤشرات التمييز ضد المسلمين في مؤسسات من المفترض أن تكون حاضنة للتعددية والتسامح. واعتبر مراقبون أن ما حدث في ناجبور ليس سوى نموذج مصغّر لانحدار خطير قد يُحوّل المدارس من منارات للعلم إلى أدوات لتكريس الانقسام والكراهية.
ويبقى السؤال معلقًا في وجدان الرأي العام: هل بات اسم “محمد” أو “فاطمة” سببًا كافيًا لإغلاق أبواب المدارس في وجه الأبرياء؟ وأين يقف الضمير الإنساني حين تتحوّل السبورة إلى منصة للتمييز بدل أن تكون نافذة للمعرفة؟