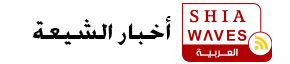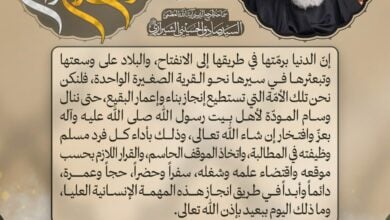تركستان الشرقية… الجرح المنسي في جسد الأمة الإسلامية

في ظل انشغال العالم الإسلامي بقضايا تتصدر العناوين اليومية، تبقى تركستان الشرقية جرحاً مفتوحاً لا يكاد يُذكر، رغم عمق معاناته. هذا الإقليم المسلم الخاضع منذ قرون للاحتلال الصيني الشيوعي يئن بصمت تحت وطأة سياسات قمعية ممنهجة تستهدف الهوية الإسلامية، والوجود العرقي للمسلمين الإيغور، في محاولة لطمس ماضيهم، وتغيير حاضرهم، ومحو مستقبلهم.
تقع تركستان الشرقية في قلب آسيا، وهي منطقة شاسعة المساحة، تزيد على مليون وستمئة ألف كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر من فرنسا بثلاثة أضعاف، وتشكّل قرابة خمس المساحة الكلية للصين. يحدها من الغرب جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية، ومن الجنوب أفغانستان والهند، ومن الشرق إقليم التبت. هذه الأرض الغنية بالتاريخ والثقافة، باتت اليوم تحت السيطرة الصينية التي فرضت عليها اسمًا جديدًا هو “سكيانج”، أي “المستعمرة الجديدة”.
عاصمة الإقليم هي مدينة “كاشغر”، وهي مركز حضاري إسلامي عريق أنجبت العديد من العلماء. يتحدث سكان الإقليم اللغة التركية، لكنهم يُجبرون اليوم على استخدام اللغة الصينية، في محاولة لسلخهم عن هويتهم الثقافية والدينية. ومنذ أن ضعفت شوكة المسلمين في الإقليم، تكالبت عليه القوى الطامعة، حتى استولت عليه الصين رسميًّا في منتصف القرن الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين بدأت حلقات طويلة من المقاومة الإسلامية، قابلتها الصين بمزيد من القمع والدماء.
السيطرة الشيوعية على تركستان الشرقية لم تكن مجرد احتلال سياسي، بل كانت بداية لمرحلة سوداء من المذابح والتضييق والتذويب. فمع دخول الشيوعيين، لم يمر وقت طويل حتى بدأوا بحملات تصفية ممنهجة، أغلقت فيها المساجد، وأُجبرت النساء المسلمات على الزواج من صينيين، وأُلغيت الملكية الخاصة، كما حُظرت المؤسسات الدينية، وتمّ فرض الفكر الشيوعي ومبادئ ماو تسي تونغ بديلاً عن القرآن والسنة. لم يكتفِ النظام الصيني بإلغاء المؤسسات الإسلامية، بل حول المساجد إلى مراكز للجنود، ومنع رفع الأذان، ومنع التعليم الديني للأطفال، وأجبر المسلمين على الخضوع لمنظومة ثقافية غريبة عن دينهم وتاريخهم.
وفي ظل ما عُرف بالثورة الثقافية، بلغ القمع ذروته، وشهدت مدينة كاشغر مجزرة مروّعة عندما حاول المسلمون أداء صلاة العيد، فواجهتهم القوات الصينية بالنار والحديد. ومع أن الصين سعت لإخفاء أخبار هذه الممارسات، فإن شجاعة المسلمين وتمسكهم بدينهم لم يفتر، فاندلعت ثورات متكررة، كان أقواها ثورة عام 1944 بقيادة علي خان، والتي أعلنت استقلال الإقليم، إلا أن هذا الاستقلال لم يدم طويلاً بسبب التحالف الصيني الروسي.
اليوم، يعيش المسلمون الإيغور في ظل نظام بوليسي يفرض عليهم حصارًا مطبقًا في كل تفاصيل حياتهم. النساء في القرى يُعاملن كالسجينات، ويخضعن لعمليات تعقيم قسري تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة بسبب الإهمال الطبي. الشباب يُمنعون من السفر، خوفًا من انضمامهم لأي نشاط معارض، والتجارب النووية تُجرى في أراضيهم بلا اعتبار لحياتهم. أما التعليم، فقد خُضع بالكامل للمنهج الصيني، دون أي مساحة للهوية الإسلامية، وحُظر استخدام الحروف العربية، كما مُنع نشر أو إدخال الكتب الإسلامية.
ورغم هذا الواقع المرير، لا تزال المقاومة حاضرة، وإن كانت في أضعف صورها بفعل القبضة الحديدية التي تحكم الإقليم. المسلمون هناك لا يزالون يؤدون عباداتهم سرًا، ويتناقلون تعليم دينهم في الخفاء، ويحتفظون بهويتهم الإسلامية بقلوب ثابتة، رغم كل ما يواجهونه من اضطهاد.
في مقابل هذا المشهد المظلم، تبدو مواقف العالم الإسلامي مخجلة إلى حد بعيد. فلا حراك سياسي ضاغط، ولا موقف إعلامي جاد، ولا دعم مالي حقيقي، ولا حتى حملة دعاء موحدة. وكأن تركستان الشرقية تقع خارج خارطة الإسلام. لا شك أن هذه القضية تتطلب يقظة ضمير وإعادة نظر، لا سيما أنها تمثل مأساة إنسانية، ودينية، وتاريخية، تستوجب من كل مسلم التحرك. الفهم الحقيقي لجذور القضية، وتسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام، وتوجيه الرأي العام العالمي نحو الانتهاكات الجارية هناك، يمكن أن يكون بداية فعلية لنصرة هذا الشعب المضطهد.
وإن لم تكن هناك قدرة مباشرة على التأثير السياسي، فإن مقاطعة المنتجات الصينية، خاصة في الدول العربية والإسلامية التي تمثل سوقًا ضخمة لها، قد يكون من أقوى الرسائل التي تُرسل إلى صناع القرار في بكين. كما أن دعم المبادرات الإغاثية والحقوقية العاملة في هذا المجال، يشكل خطوة عملية في دعم المقاومة الشعبية هناك.
تبقى تركستان الشرقية رمزًا للمظلومية الإسلامية الحديثة، وشاهدًا على صمت العالم المريع تجاه جرائم ترتكب في وضح النهار. لكنها أيضًا صورة حية للثبات والصبر، فالمسلمون هناك لا يزالون متمسكين بعقيدتهم، يورثون أبناءهم الإسلام كما ورثوه عن آبائهم، رغم كل ما يلاقونه من قهر وظلم.